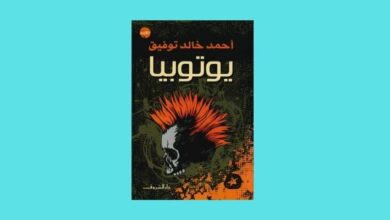رأي
المنهاج الخفي , الرغبة في التعلم , وساطة المدرس 3 لامرئيات في مهنة التعليم

المنهاج الخفي كخبرة مدرسية معيشة
في القسم وفي بناء الدرس بين المدرس والمتعلمين، يظن كثيرون أن التدريس يبدأ من الكتاب وينتهي عند آخر جملة في الدرس. لكن ما يجري فعلا أوسع من ذلك بكثير. هناك نص ثان يكتب نفسه في الخلفية، بلا عناوين ولا فقرات، ومع ذلك يترك أثرا أعمق من المحتوى. إنه المنهاج الخفي، ذلك الذي يتشكل من الإيماءات الصغيرة، ونبرة الصوت، وطريقة توزيع الانتباه، ومنطق الثواب والعقاب، وكيفية التعامل مع الخطأ، ومع الضعف، ومع الاختلاف. كأن المدرس يكتب على سبورة ثانية لا يراها أحد، لكنها تظل في ذاكرة المتعلم طويلا.
هذا المنهاج لا يشتغلل بالكلمات فقط، بل يعمل بما يسميه علم الاجتماع التربوي التطبيع المدرسي، أي تحويل سلوكات معينة إلى قاعدة تبدو طبيعية. حين يمدح المدرس الإجابة المرتبة أكثر من الجرأة، أو حين يكافئ الصمت أكثر من السؤال، أو حين يمرر انضباطا صارما بدون تفسير، فإنه يعلم، دون قصد أحيانا، ما يعتبره النظام سلوكا صحيحا. هنا تصبح القيم خيوطا دقيقة في نسيج اليوم المدرسي: من يستحق الكلام؟ من يستحق الاعتراف؟ من يحق له أن يخطئ؟ المنهاج الخفي يعمل مثل هواء الغرفة: لا نراه، لكننا نتنفسه، ويتحول إلى جزء منا.
ولهذا السبب، لا يمكن فهم الأثر العميق للمنهاج الخفي دون استحضار مفهوم العنف الرمزي. فبعض الرسائل التي تمر عبر التفاصيل قد تحمل، دون نية مباشرة، تفضيلا لذوق معين، أو لغة معينة، أو طريقة معينة في التعبير، فتجعل بعض المتعلمين يشعرون أن المدرسة تشبههم، بينما يشعر آخرون أنها بعيدة عنهم. هنا لا يظهر الأمر كظلم صريح، بل كميل صامت داخل العادي واليومي. كأن المنهاج الخفي يحدد من يملك حق الارتياح داخل الفضاء المدرسي، ومن يضطر إلى بذل جهد مضاعف فقط كي يبدو طبيعيا.
ومع ذلك، لا ينبغي أن ننظر إلى المنهاج الخفي بوصفه فخا دائما. فالمدرس، حين يعيه، يستطيع أن يحوله إلى طاقة تربوية نبيلة. يمكنه أن يجعل الإنصاف عادة يومية لا شعارا، وأن يجعل احترام الاختلاف ممارسة لا خطابا، وأن يجعل الخطأ فرصة تعلم وليس وصمة. ويستحسن هنا استحضار فيليب جاكسون 1970 Philip Jackson ، الباحث الذي اشتهر بتحليل فكرة المنهاج الخفي، ليس بهدف تحويل الفكرة إلى درس نظري، بل لكي نلتفت إلى ما يحدث فعلا بين لحظة وأخرى: كيف تشتغل المدرسة كخبرة معيشة، لا كمقرر فقط. المنهاج الخفي ليس شيئا خارجنا، بل هو ما نصنعه كل يوم ثم ننساه، مثل أثر خطواتنا على الرمل.
المدرس، في العمق، لا يعلم التلميذ كيف يجيب فقط، بل يعلمه كيف يرى نفسه داخل العالم المدرسي. هل يشعر أنه مرحب به؟ هل يشعر أن صوته مسموع؟ هل يشعر أن جهده معترف به حتى حين لا ينجح؟ هذه كلها معارف قيمية، لا تختبر في ورقة، لكنها ترسم علاقة المتعلم بالتعلم. المنهاج الخفي يشبه ضوءا خافتا في الممر: لا يلفت الانتباه، لكنه يحدد اتجاه السير.
حين نرفع وعينا بالمنهاج الخفي، لا نثقل المهنة، بل نحررها. لأن أدق ما في التربية هو أن تجعل الإنسان أكثر إنسانية، وليس فقط أكثر معرفة واجتهادا. وحين ينجح المدرس في أن يمرر، عبر التفاصيل اليومية، معنى العدل والكرامة والأمل، يصير المنهاج الخفي أجمل ما في المدرسة: رسالة لطيفة لا بدون ضجيج، لكنها أثرها عميق وقوي…
كيف تبنى الرغبة في التعلم دون أوامر؟؟
في بعض الأحيان، يلاحظ المدرس أن متعلما أو متعلمين يلجأون إلى الانسحاب من المشاركة أو التفاعل الصفي في القسم، ليس بسبب كونهم لا يفهمون، بل لأن شيئا أعمق د تعرض لجرح أو انكسار داخلي. قد يكون المتعلم ذكيا ومنتبها، بل قادرا على التحليل والنقد، ومع ذلك ينسحب بصمت، ويفقد الرغبة، ويجلس في آخر الصف كمن أطفأ الضوء من تلقاء نفسه. هنا لا تكفي لغة المحتوى ولا منطق الشرح. ما يحدث ينتمي إلى منطقة خفية من الفعل التربوي: منطقة الدافعية، حيث لا تقاس المعرفة بما يقدمه المدرس في الحصة، بل بما سيكتسبه المتعلم.
تفسر نظرية ديشي ورايان، عالما النفس الأمريكيين، هذا العمق من خلال ما سموه نظرية التحديد الذاتي (Edward L. Deci و Richard M. Ryan، – Théorie de l’autodétermination (SDT Self-Determination Theory ) ). وجوهر هذه النظرية أن الدافعية لا تفرض من الخارج، بل تنمو من الداخل حين تتم تلبية ثلاث حاجات نفسية أساسية. والمدرس، دون أن يعلن ذلك، يشتغل يوميا على هذه الحاجات، إما بتغذيتها وتنشيطها، أو بخنقها دون قصد.
الحاجة الأولى هي الشعور بالكفاءة (sentiment de compétence). فالمتعلم لا يحتاج فقط إلى النجاح، بل إلى الإحساس بأنه قادر وله كفاءة. حين يختار المدرس تمرينا في مستوى دقيق، أي تمرينا يتجاوز السهل حتى لا يفرغ من معناه، ولا يصل الصعب الذي يولد العجز، فإنه يبني هذا الشعور بصمت. فعيارات مثل “أنت اقتربت”، أو “ تابع الفكرة في طريقها”، “دقق أكثر فأنت على وشك”…قد تساوي أكثر من نقطة. وحين يحرم المتعلم من هذا الإحساس، حتى لو كان ذكيا، يبدأ الانسحاب الداخلي: ليس لكونه لا يفهم، بل لأنه لم يعد يثق في قدرته على الفهم.
الحاجة الثانية هي الاستقلالية (autonomie). وهي لا تعني الفوضى، بل الإحساس بأن للمتعلم هامشا من القرار، ومن الاختيار والمبادرة. حين يسمح المدرس بتعدد الأجوبة، أو يترك للتلميذ طريقة حل مختلفة، أو يصغي لسؤال خارج النص، فإنه يقول له دون كلام: “أنت شريك في التعلم، لا مجرد منفذ”. هذا الإحساس الدقيق بالاستقلالية يصنع دافعية هادئة، لأن المتعلم يشعر أن التعلم يخصه، ولا يفرض عليه. لكن حين تسلب منه هذه المساحة، يتحول القسم إلى فضاء امتثال، وتتحول الدافعية إلى طاعة مؤقتة.
أما الحاجة الثالثة، وهي الأعمق أحيانا، فهي الانتماء (sentiment d’appartenance). أن يشعر المتعلم بأنه مرئي، ومسموع، ومعترف به داخل الجماعة. ذلك ان نظرة المدرس ونبرة صوته، وطريقته في توزيع الانتباه، كلها عناصر تخلق وتبني هذا الشعور أو تهدمه. إن المتعلم قد يتحمل صعوبة الدرس، لكنه لا يتحمل الإقصاء الرمزي. وحين يغيب الانتماء، يفقد التعلم معناه، لأن الإنسان لا يتعلم في فراغ وجداني.
أعتقد أن ما يجعل هذه النظرية مناسبة لقراءة لامرئية المهنة هو أن المدرس لا يطبقها كمنهج، بل يعيشها كممارسة يومية. ففي حصة واحدة، قد يعزز الكفاءة دون أن يسميها، ويفتح هامشا للاستقلالية دون أن يعلنه، ويصنع مناخ انتماء دون أن يخطط له. هذا العمل لا يظهر في التخطيط والجذاذات ودفاترالنصوص، لكنه يحدد مصير الدافعية داخل القسم.
وبذلك نفهم لماذا ينهار متعلم رغم ذكائه: لأن إحدى هذه الحاجات الثلاث لم تتم تغذيتها وسقيها. ونفهم أيضا كيف يصنع المدرس مناخا دافعيا دون أن يراه أحد: وهو لا يصنع ذلك عبر التحفيز البلاغي، بل عبر تفاصيل صغيرة، تشبه الماء الذي يتسرب إلى الجذور دون ضجيج.
حين نقرأ القسم على ضوء نظرية التحديد الذاتي، نكتشف أن التدريس ليس توجيها خارجيا وليس دفعا من الخلف، بل مرافقة من الداخل ومواكبة عميقة. المدرس لا “يصنع” الدافعية، بل يهيئ شروط نموها. وحين ينجح في ذلك، لا يظهر النجاح في الضجيج، بل في شيء أبسط وأعمق: في حالة متعلم يريد أن يتعلم، لأنه يشعر أن التعلم مهمته وخاصيته ووضعه الطبيعي.
وساطة المدرس ومنطقة العبور المعرفي للمتعلم ..
في عديد الأحيان، لا يبدو المدرس وهو يعلم فقط، بل يبدو خلف المظهر مرافقا ومواكبا وميسرا. إنه لا يدفع المتعلم دفعة واحدة نحو الفهم الجاهز، ولا يتركه يسقط في وضع العاجز ، بل يتحرك في منطقة دقيقة بين العتبتين. يراقب، وينتظر ويتدخل بخفة، ثم ينسحب. ما يحدث هنا غير مرئي في الجذاذات ولا في التخطيط، لكنه جوهر الفعل التربوي: وضع السلم ثم إخفاؤه.
يجد هذا العمل الخفي تفسيره العميق في نظرية عالم النفس السوفياتي ليف فيغوتسكي Lev Vygotsky، خاصة مفهوم منطقة النمو القريب – Zone proximale de développement. في هذه المنطقة، لا يكون المتعلم عاجزا تماما، ولا مستقلا تماما، بل “قريبا” من الفهم، يحتاج فقط إلى وساطة دقيقة كي يعبر وينمو أكثر. والمدرس، في هذه اللحظة، لا يضيف معرفة جديدة، بل يخلق شرط إمكانها.
حين يطرح المتعلم جوابا ناقصا، لا يصححه المدرس مباشرة.د، بل يبتسم أحيانا، يعيد صياغة السؤال، يضيف تلميحا صغيرا، أو يسأل سؤالا فرعيا يفتح نافذة للفهم. يبدو وكأنه يماطل ويرواغ بأناقة بيداغوجية، لكنه في الحقيقة يفكك المسألة دون أن يسحبها من يد المتعلم. هذا التردد المقصود، وهذه الخطوة الصغيرة إلى الخلف، هي فعل مهني عميق: المدرس يترك للمتعلم شرف الوصول.
وفي لحظات أخرى، حين يشعر المدرس أن المتعلم اقترب من العجز، يتدخل بسرعة محسوبة ودقيقة. لا يشرح كل شيء، بل يضع علامة او مثالا، أو كلمة مفتاح. كأنه يمد يده فقط كي لا يسقط المتعلم، ثم يتركه يكمل السير وحده. هذه الحركة الدقيقة هي جوهر الوساطة – Médiation كما تصورها فيغوتسكي: فهي لا تتمثل في نقل المعرفة، بل في تنظيم العلاقة بينها وبين المتعلم.
ما لا نراه ولا نعلنه هو أن المدرس يشتغل هنا على خط رفيع جدا. فكل خطوة زائدة، تجعل الدعم تبعية. وكل خطوة ناقصة تحول التعلم إلى إحباط. لذلك يبدو المدرس وكأنه يزن تدخله بميزان حساس: متى أشرح؟ متى أسكت؟ متى أُعيد السؤال؟ متى أترك الصمت يعمل؟ هذا التفكير اللحظي لا نراه ولا تقبسه، لكنه يستهلك جهدا إدراكيا كبيرا، لأنه يحدث في الزمن الحقيقي للحصة.
في العمق، لا يشتغل المدرس فقط على المحتوى، بل على الثقة المعرفية للمتعلم. فحين ينجح المتعلم في حل مسألة بمساعدة غير مباشرة من مدرسه، لا يتعلم الحل فقط، بل يتعلم أنه قادر. وهنا يتحقق ما قصده فيغوتسكي: التعلم الحقيقي هو الذي يتحول إلى نمو داخلي. المدرس، في هذه اللحظة، لا يصنع الإجابة، بل يصنع القدرة على الإجابة.
هذا العمل الوسيط يبقى خلف الإنجازالرسمي الظاهر. التلميذ يتذكر أنه “فهم وحده”، والإدارة ترى نتيجة، والمقرر يتم انجازه. لكن المدرس يعرف، في داخله، أنه كان هناك، في اللحظة المناسبة، بالكلمة المناسبة، وبالصمت المناسب. كان مثل من يحمل سلما خلف الجدار، يسمح للآخر أن يصعد، ثم يختفي.
وهذه إحدى أعمق لامرئيات مهنة التعليم: أن ينجح المدرس حين لا نراه، وأن يكون أثره أكبر حين لا ينسب إليه.